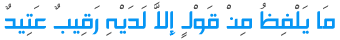| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
|  |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
 الثلاثاء 1 سبتمبر - 12:30:10 الثلاثاء 1 سبتمبر - 12:30:10 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط 
|  موضوع: بحث: ستون عاماً من الصراع العربي-الإسرائيلي: جدلية المقاومة والتسوية موضوع: بحث: ستون عاماً من الصراع العربي-الإسرائيلي: جدلية المقاومة والتسوية بحث: ستون عاماً من الصراع العربي-الإسرائيلي: جدلية المقاومة والتسوية بحث: ستون عاماً من الصراع العربي-الإسرائيلي: جدلية المقاومة والتسوية  د.أحمد يوسف أحمد في صراع مصيري كالصراع العربي-الإسرائيلي تكتسب الأسئلة حول الطرق المثلى لإدارته أهمية فائقة، إذ يترتب على الإجابات الصحيحة لهذه الأسئلة إمكان تحقيق طرف ما لأهدافه، أو على الأقل لجزء منها. وبعد مرور ستين عاماً على نشأة دولة إسرائيل التي تعد علامة فارقة في تطور هذا الصراع يزداد إلحاح الحاجة إلى البحث عن الإجابات الصحيحة خاصة وأن كلاً من منهجي المقاومة والتسوية يبدو مأزوماً، ولذلك فإن من شأن البحث أن يساعد على إيضاح الأمور ومن ثم اتخاذ قرارات رشيدة. أولاً- المقاومة أو التسوية: دروس الخبرة العملية: يشتد الجدل في الآونة الراهنة على الصعيد العربي عامة والفلسطيني خاصة حول نهجي التسوية والمقاومة خاصة وقد انفرط عقد فصيلي المقاومة الرئيسيين في فلسطين جغرافياً وسياسياً بسيطرة حماس المتبنية خيار المقاومة على قطاع غزة وسيطرة فتح التي تتبنى قيادتها خيار التسوية على الضفة الغربية. فهل يمكن أن تقدم القراءة المقارنة لخبرات التحرر الوطني المعاصرة دروساً مفيدة في هذا الصدد؟ كقانون عام يكون التناقض بين المشروع الاستعماري والوطنيين واضحاً منذ بدايته فيؤدي إلى إرهاصات لمقاومة وطنية عفوية للاستعمار تأخذ عادة في البداية الطابع العنيف ربما لتصور جدواها في دحض المشروع الاستعماري نظراً لعدم الإلمام بأبعاده المتكاملة ومدى ضراوته، ومع مرور الوقت "تتعلم" الحركات الوطنية المزيد عن المشاريع الاستعمارية فتهدأ إلى حين، و"تتعلم" السلطات الاستعمارية المزيد عن حركات التحرر الوطني فتحسن في أساليبها في مواجهتها، غير أن التناقض يأخذ في التجذر مرحلة بعد مرحلة فتستمر هذه الحركات في نضالها وتوسع نطاقه أفقياً على المستويين الاجتماعي –بضم طبقات جديدة للنضال- والجغرافي –بانتشار مكاني أوسع له، وتطور أساليبه رأسياً على مستوى أشكال النضال وأدواته، فاستمرار حركات التحرر الوطني في نضالها ليس إن مجرد نبض روتيني يشير إلى بقاء الحياة، وإنما هو إرادة فعل متزايدة تتحرك بثبات –بسرعة أحياناً وببطء في أغلب الأحيان- نحو تحقيق أهدافها، ولا يعني الاستمرار، كما تشير خبرات أغلب حركات التحرر الوطني، النضال –اليومي- الذي لا يتوقف لحظة واحدة، فهناك التوقف الذي أعقب الهزائم والنكسات التي بقيت بالمنظور التاريخي ظاهرة مؤقتة في المسار العام لعملية التحرر الوطني، وهناك التوقف الذي كان يعني إعادة الحسابات والتخطيط للمواجهة. ويؤدي هذا المسار المستمر تاريخياً والمتصاعد موضوعياً لحركات التحرر الوطني إلى آلية أكيدة لتآكل المشروعات الاستعمارية نتيجة للضرر المتزايد الذي تلحقه هذه الحركات بمستعمريها، وفي البداية يصل الإخفاق في إدراك حقيقة الموقف وجوهر التاريخ من قبل المستعمرين إلى حد العمى الكامل فيتصورون أن حركات التحرر الوطني ما هي إلا ظواهر مؤقتة تطفح على جلد المشروعات الاستعمارية فيعملون على استئصالها بأعمال القوانين والنظم الاستعمارية من خلال استخدام مكثف لأدوات الإكراه، ويرتبط ذلك عادة بمواقف سياسية بالغة التطرف ضد مطالب هذه الحركات تكون هي في حد ذاتها بعد ذلك خير دليل على بداية التآكل الحقيقي في المشروع الاستعماري عندما تبدأ هذه المواقف في التغيير تحت وطأة الضغط المستمر والضربات المتزايدة لحركات التحرر. وعند نقطة معينة يكون من الواضح أن تكلفة المشروع الاستعماري قد أصبحت تفوق العائد المترتب عليه، وعادة ما يستمر العمى لدى نظام الحكم القائم في الدولة الاستعمارية فلا تحدث الاستجابة المطلوبة للمتغيرات الجديدة النابعة من بيئة حركات التحرر الوطني، وهنا تصل آلية التآكل إلى قمتها بحدوث تغيرات سياسية في معسكر المستعمر قد تكون جذرية في بعض الأحيان، وتضطلع السلطة الجديدة في الدول الاستعمارية بمهمة التكيف مع حركات التحرر الوطني بضرورة التسليم بمطلبها في الاستقلال السياسي. ومن الأهمية بمكان أن نناقش في سياق تحليل ظاهرة المقاومة الوطنية لعمليات الاستعمار والاحتلال الأجنبيين العلاقة الجدلية بين الكفاح المسلح والنضال السلمي، فليس صحيحاً أن كل مقاومة ينبغي أن تكون مسلحة أو يستحسن أن تكون ذات طابع سلمي. تظهر القراءة المتأنية لمسار حركات التحرر الوطني من منظور أساليب النضال أن ثمة نموذجاً يكاد أن يكون عاماً تنكشف أبعاده من خلال هذا المسار، إذ أن تطبيق المشروعات الاستعمارية على أرض الواقع من خلال الغزو العسكري بصفة خاصة يولد إرادة المقاومة لدى الشعوب المعرضة لهذه المشروعات تنعكس في شكل مقاومة عنيفة لهذا الغزو، غير أن الخلل العام في ميزان القوى بين الاستعماريين والوطنيين يؤدي بعد فترة تطول أو تقصر وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة على حدة، إلى إخماد المقاومة العنيفة للوطنيين. وتمر مرحلة من السكون من الواضح أن المجتمع المقهور يتأمل خلالها في كل ما جرى، ويعيد حسابات المواجهة، وذلك في الوقت الذي تكون فيه أبعاد المشروع الاستعماري قد بدأت تتكشف شيئاً فشيئاً عن أبشع صور الاستغلال والقهر لجماهير الوطنيين، وتبرز المقاومة من جديد باعتبارها الطريق الوحيد والحتمي للخلاص، غير أنها تأخذ في البداية الطابع السلمي السياسي وربما الوعي بالخلل الهائل بين معسكر الاستعمار ومعسكر التحرر، وتبرز طلائع من الوطنيين لقيادة عملية المقاومة، ويتم بالتدريج جذب مزيد من القوى الاجتماعية في عدد أكبر من المناطق إلى معسكر التحرر، وفي لحظة معينة يتأكد إفلاس الطابع السلمي السياسي وحده، وتبرز ضرورة إدخال الكفاح المسلح في المجرى العام للنضال، وتنطلق الشرارة الأولى في اللحظة التي تثق فيها طلائع التحرر في قدرتها على تحقيق النصر. لكن تبني الكفاح المسلح لا يعني في حد ذاته انتهاء المشكلات، فهناك بطبيعة الحال مشكلات مواجهة العنف المضاد من الاستعماريين، وهناك مشكلة العلاقة بين النضال العسكري والنضال السياسي خاصة عندما يكون لكل من الأسلوبين رجاله، وهناك مشكلة الدعم الخارجي للكفاح المسلح، والذي يتوقف على ظروف لا تسيطر عليها هذه الحركات بطبيعة الحال، وتؤدي هذه الظروف في أحيان غير قليلة إلى تقلبات غير مواتية في هذا الدعم. وفي مواجهة هذه الإشكاليات يلاحظ أن الكفاح المسلح في بعض حركات التحرر الوطني قد سار -على الرغم من كافة الصعوبات الهائلة- في مسار صاعد وصولاً إلى الاستقلال السياسي الكامل، بينما أصيب في حركات أخرى بانتكاسات واضحة أو على الأقل لم يفض إلى نتائج فعالة في المواجهة مع المشروع الاستعماري، الأمر الذي يفتح الباب للحديث عن "النضال السلمي". وهنا يمكن الإشارة إلى الملاحظات الأربعة التالية: الملاحظة الأولى أن الخيار بين النضال السلمي والكفاح المسلح ليس خياراً "مبدئياً" في حركات التحرر الوطني وإنما هو خيار يتعلق بالتكتيك، ومن ثم فإن الانتقال من أسلوب إلى آخر أو المزاوجة بينهما بحسب الظروف لا تمثل "تنازلاً" أو "تشدداً" أو "وسطية" في حد ذاته، ذلك أن الأمر يجب أن يقاس بالعائد الذي يترتب على أي أسلوب يتبع من منظور تحقيق حركة التحرر الوطني لأهدافها. وقد يقال في هذا الصدد: وما الذي يستطيع النضال السلمي أن يحققه من عائد؟ وهنا نسارع إلى القول بأن الخيار المطروح ليس خياراًَ بين "اللاقوة" و"القوة" فالقوة ليست بالضرورة مسلحة، والمقاطعة الاقتصادية مثلاً أسلوب سلمي يمكن أن يرتب نتائج أكثر فعالية بكثير من الكفاح المسلح في ظروف معينة بالنسبة لعملية التآكل الاستعماري، وقد فشلت بريطانيا في الهند لأن الشعب الهندي بقيادة غاندي نجح في تحويل ضعفه من المنظور المسلح إلى قوة سياسية، وذلك باستخدام وسائل غير مسلحة نجحت في ضعضعة الاحتلال وإداراته وثقته بنفسه. والملاحظة الثانية أن الخيار بين النضال السلمي والكفاح المسلح لا يبدو بأي حال خياراً نظرياً، وذلك بمعنى أن أساليب النضال التي تأخذ بها حركات التحرر الوطني تتبلور من خلال تطور عملية التحرر ذاتها، ولا نقصد بذلك أن نقاشاً لا يحدث في صفوف حركة التحرر الوطني حول هذه المسألة، ولكننا نقصد معنيين محددين: أولهما أن هذا الخيار لا يمكن أن يفرض من أعلى بتحليلات أكاديمية على سبيل المثال، أو من خارج الحركة التحررية ذاتها، وثانيهما أن الانتقال الفعلي إلى أسلوب محدد من أساليب النضال يحدث على أرض الواقع عندما يدرك المناضلون جدوى هذا الانتقال. ومع ذلك فثمة فائدة أكيدة دون شك في دراسة الخبرات التحررية الأخرى واستخلاص الدروس منها في هذا الخصوص ووضعها أمام المناضلين لمجرد الاسترشاد بها. والملاحظة الثالثة أنه في مجال المفاضلة بين النضال السلمي والكفاح المسلح تبدو حجة التحسب لردود الفعل العنيفة من جانب السلطات الاستعمارية إزاء لجوء حركة التحرر الوطني للكفاح المسلح حجة واهية. إذ تظهر خبرات التحرر الوطني أن هذه السلطات قد عاملت كلاً من النضال السلمي والكفاح المسلح بنفس العنف. وليست لدينا بطبيعة الحال أرقام محددة عن ضحايا النضال السلمي والنضال المسلح كل على حدة حتى نقول إن هذا الأسلوب أكثر "أماناً" من ذاك، ومن المؤكد أن الشعوب لا تسأل نفسها أصلاً مثل هذه الأسئلة الترفية وهي تواجه الاستغلال والقهر الاستعماريين، لكن الثابت على الأقل أنه لم يكن هناك تناسب على الإطلاق بين رد الفعل الاستعماري وبين الفعل التحرري السلمي، وتبرز المذابح الجماعية للوطنيين المسالمين في الهند والجزائر وفلسطين وجنوب أفريقيا وغيرها شاهداً على ذلك. بل إن عدم التناسب هذا كان في حد ذاته هو العامل الذي حسم ضرورة الأخذ بالكفاح المسلح في عدد من الحالات. والملاحظة الرابعة والأخيرة أن الجدل النظري حول الخيار بين النضال السلمي والكفاح المسلح يظهر المسألة –ربما لأنه نظري- وكأنها "إما" "أو"، مع أن الخبرات العملية تشير إلى الحدوث الفعلي على أرض الواقع للمزاوجة بين الخيارين. ويشير النموذج العام لتطور حركات التحرر الوطني إلى نجاحها في تحقيق هدف الاستقلال السياسي من المستعمر، غير أن هناك تمايزاً واضحاً في صور الحصول على هذا الهدف، فهناك من هذه الحركات ما نجح في انتزاع الاستقلال انتزاعاً بقوة السلاح بحيث أن الاتفاق الذي وقع مع المستعمر لم يكن سوى تسليم منه بالأمر الواقع الموجود في الساحتين العسكرية والسياسية، ويكون الحصول على الاستقلال السياسي على هذا النحو حلاً نهائياً للتناقض السياسي بين الاستعمار وحركات التحرر الوطني لصالح الأحيرة، ويمكن أن نلحق الخبرات الفيتنامية والجزائرية واليمنية والأنجولية بصفة عامة بهذه الصورة من صور تحقيق الاستقلال السياسي، غير أن هناك من حركات التحرر الوطني ما حصل على الاستقلال السياسي من خلال تسوية تتضمن حلولاً وسطاً في إطار التسليم بمطلب الاستقلال بطبيعة الحال، وذلك نتيجة لكون النضال التحرري لم يحسم بعد لصالح حركات التحرر، ويمكن أن نستشهد هنا بخبرات التسوية في الجنوب الأفريقي (زيمبابوي وناميبيا وجنوب أفريقيا). وتحدث التسوية عادة لأن حسابات طرفي الصراع تشير بدرجة أو بأخرى إلى وجود مصلحة في التسوية، فعلى الجانب الاستعماري سبقت الإشارة إلى عملية التآكل التي يتعرض لها والتي يأتي وقت لابد أن يشعر بآثارها الحتمية، وفي هذه اللحظة يصبح من الحكمة بالنسبة لمعسكر الاستعمار أن يبادر بإظهار المرونة والاستعداد للتسوية، لتحقيق أكثر من هدف، فهو أولاً يأمل في أن يحقق له هذا السلوك المرن فترة لالتقاط الأنفاس في مواجهة تصاعد النضال التحرري سلمياً وعسكرياً في حالة نجاح بالونات المرونة التي يطلقها في تحذير الحركة الوطنية وإشاعة الانقسام في صفوفها، وهو يأمل ثانياً في أن يحصل من خلال المفاوضات على أفضل الشروط خاصة إذا نجح في تحقيق الانقسام في صفوف الوطنيين واستغلاله. وهو يأمل ثانياً في أن يفضي هذا كله إلى ضمان أن يجئ مجتمع ما بعد الاستقلال على النحو الذي يكفل لمصلحة الاستمرار. وإذا كانت هذه هي الدوافع التي تحرك المعسكر الاستعماري نحو التسوية، فما الذي يدفع حركات التحرر التي يفترض فيها أن تكون مسلحة –خاصة إذا كنا نتحدث عن تجارب استمرت في نضالها إلى عقد الثمانينات- بوعي كامل بحتمية النصر إلى قبول الحلول الوسط؟ يجب ألا ننسى ونحن نحاول الإجابة على هذا السؤال أننا نتحدث عن نضال فعلي وليس عن مجادلات نظرية، وهنا فإن حركات التحرر الوطني التي تتعرض بدورها لا للتآكل، فمسارها صاعد تدريجياً كما رأينا، وإنما لخسائر مادية وبشرية رهيبة، ولانقسامات –شديدة في بعض الأحيان- في صفوفها، ولتناقض أو توقف مصادر الدعم الخارجي في ظروف معينة، وهنا يثور الجدل داخلها بقوة حول جدوى القبول بالتفاوض، وقد يؤدي هذا الجدل إلى مزيد من الانقسام كما يطمح العدو، وقد يصل الأمر إلى حد انسلاخ الفصائل الأكثر اعتدالاً والتي تكون عادة الأقل أداءً في ميدان النضال ومسارعتها بالسير في اتجاه العدو مما يخلق ضغوطاً إضافية على الفصائل الأكثر نضالية في اتجاه قبول التسوية، وعادة ما ينتهي الأمر بقبولها وبدء مرحلة من النضال السياسي، ويكون من الأهمية بمكان هنا أن يأتي هذا القبول في التوقيت السليم من وجهة نظر حركات التحرر، والذي يفترض فيه أن يشير إلى توازن ولو نسبي في القوة بينها وبين معسكر الاستعمار وإلا فإن قبول التسوية لن يكون سوى بداية لقبول التنازلات. وتتضمن هذه المرحلة عادة أعمالاً تفاوضية مع العدو سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وتواجه حركات التحرر الوطني هنا في سلوكها التفاوضي بمشكلة التنازلات التي يجب أن تقدمها، وفي الواقع أنها طالما رضيت بدخول المفاوضات في الإطار السابق فلابد من توقع أنها ستقدم تنازلات، ويقدم بعضها بالفعل تنازلات واضحة إما كتكتيك سليم أو كخطأ جسيم، وقد يترتب الخطأ أصلاً على سوء توقيت قبول التسوية، ومن هنا فإن شروط التسوية تكون مهمة للغاية في العملية النهائية للحصول على الاستقلال سواء هذه الخاصة بالمرحلة الانتقالية أو تلك المتعلقة بتنظيم مجتمع ما بعد الاستقلال، وقد تؤثر هذه الشروط على أمور بالغة الأهمية مثل طبيعة القوى الحاكمة في هذا المجتمع. وهذا يجعل الحديث عن الضمانات الموضوعية لمرحلة ما بعد الاستقلال يكتسب أهمية خاصة، وإن كان هذا موضوع آخر. ثانياً- موقع الصراع العربي-الإسرائيلي من جدلية المقاومة والتسوية: في محاولة الاستفادة من الدروس السابقة التي أمكن استخلاصها من الخبرات المعاصرة لحركات التحرر الوطني يمكن الإشارة إلى ثلاث ملاحظات رئيسية. أما الملاحظة الرئيسية فتكشف عن أن الصراع العربي-الإسرائيلي قد سار وفقاً لنموذج حركات التحرر الوطني الذي سبقت الإشارة إليه، وقد بدأ النضال التحرر الفلسطيني كرد فعل لتبلور المشروع الصهيوني على فلسطين منذ الربع الأول من القرن الماضي، وما انتفاضة البراق في العشرينيات وثورة1936 في الثلاثينات من ذلك القرن إلا علامتان بارزتان في هذا الصدد، وفي أعقاب إعلان دولة إسرائيل على معظم أراضي فلسطين في1948 استمرت المقاومة الفلسطينية المسلحة وإن اتخذت في البداية طابعاً عفوياً غير منظم، ثم بدأ الكفاح المسلح المنظم في1965 على أيدي حركة "فتح"، وفي1967 وبعد الهزيمة العربية في مواجهة العدوان المسلح في تلك السنة واحتلال أراض تابعة لثلاث دول عربية هي مصر وسوريا والأردن دخلت هذه الدول على خط استخدام الأداة العسكرية في الصراع مع إسرائيل بشكل أو بآخر كما في حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية اعتباراً من عام1968 وكما في حرب أكتوبر1973 التي كانت عملاً مشتركاً بين مصر وسوريا. وإذا كانت الظروف الذاتية الخارجية بالنسبة للنضال الفلسطيني المسلح قد أدت إلى محدودية نتائجه حتى نهاية الستينات فإن هذا النضال في السبعينات وبصفة خاصة في الثمانينات قد وصل إلى مستوى جماهيري غير مسبوق بالغاً ذروته في انتفاضة الحجارة في نهاية ذلك العقد وتحديداً اعتباراً من ديسمبر1987 وحتى تفجر أزمة الخليج الثانية باحتلال العراق للكويت في أغسطس1990، وبعد فترة من الهدوء الذي سببته ملابسات التسوية في العقد الأخير من القرن العشرين تفجر النضال الفلسطيني المسلح في شكل انتفاضة الأقصى اعتباراً من سبتمبر2000 وحتى الآن. وتضاف إلى سجل الكفاح العربي المسلح في الصراع العربي-الإسرائيلي بطبيعة الحال المقاومة اللبنانية التي بزغت في لبنان اعتباراً من ثمانينات القرن الماضي وتمحورت لاحقاً حول حزب الله. ويلاحظ أن كافة الإنجازات التي حققها العرب حتى الآن على صعيد الصراع مع إسرائيل قد تحققت بفضل المقاومة وحدها، فلم يكن ممكناً أن تقبل إسرائيل الانسحاب من باقي شبه جزيرة سيناء لو لم تكن القوات المصرية قد أثبتت بأدائها قبل حرب أكتوبر وأثناءها وبعدها أنها قادرة على إلحاق الهزيمة بالمحتل أو على الأقل رفع تكلفة بقائه في شبه جزيرة سيناء إلى درجة لا يحتملها، ولم يكن ممكناً انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان بعد احتلالها في1982 بدون المقاومة اللبنانية والفلسطينية بوجه الاحتلال، ولم يكن ممكناً أن تهرب إسرائيل من الشريط الحدودي الجنوبي في لبنان في2000 بدون مقاومة حزب الله، ولم يكن ممكنًا أن تفشل في تحقيق أهدافها في لبنان من خلال عدوانها عليه في صيف2006 بدون الأداء القتالي الرفيع لحزب الله. وعلى الصعيد الفلسطيني لم يكن ممكناً أن تقبل إسرائيل الاعتراف بالشعب الفلسطيني ومنظمته –كما جاء في اتفاقية أوسلو1993- بدون انتفاضة الحجارة، ولك يكن ممكناً لشارون أن يتخلى عن قطاع غزة ويفكك مستوطناته الاستعمارية في2005 لو لم تتفجر انتفاضة الأقصى وتفشل القوات الإسرائيلية المرة تلو المرة في القضاء عليها، ومن منظور زمني ممتد فإن تحول السياسة الإسرائيلية من اعتبار الضفة والقطاع بالكامل أراضٍ إسرائيلية محررة إلى قبول فكرة إنشاء دولة فلسطين على جزء منها –مهما كان الجزء ضئيلاً- ليس إلا ثمرة من ثمار المقاومة. تكشف الملاحظة الثانية عن أن الصراع العربي-الإسرائيلي قد دخل أيضاً مسار التسوية وفقاً للنموذج السابق بيانه لحركات التحرر الوطني المعاصرة، غير أن المشكلة أن الطرف العربي قبل مبدأ التسوية في لحظة انكسار (هزيمة يونيو1967) ولذلك ظل نموذج التسوية مع إسرائيل متأثراً بهذه الحقيقة التي تشير إلى خلل بنيوي في ميزان القوى العربي-الإسرائيلي، ولذلك فإن التسويات العربية-الإسرائيلية إما أنها لم تتم أصلاً (المسار السوري) وإما أنها تمت وإن بشكل لا يحقق تطلعات الطرف العربي بالكامل كما في المسار المصري الذي تعيب التسوية فيه الشروط المتعلقة بتوزيع القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الفاصلة بين مصر وإسرائيل، وهو توزيع ثبت مؤخراً أنه غير قادر على التصدي لاجتياح جماهيري فما بالنا بعدوان من دولة إقليمية كبرى، وإما أنها –أي التسويات العربية-الإسرائيلية- قد انتكست دوماً وعادت إلى نقطة الصفر (اتفاقية كامب ديفيد الثانية الخاصة بتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي على المسارين الأردني والفلسطيني في1978- اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في1993- خارطة الطريق الأمريكية2003، ويلاحظ أن ثمة إنجازات لافتة قد تحققت دون تسويات أصلاً كما في طرد القوات الإسرائيلية من لبنان بعد واقعة احتلاله في1982 ثم من الشريط الحدودي الجنوبي في ذلك البلد في2000 ثم التصدي الناجح للعدوان الإسرائيلي في2006. ويعني ما سبق أن الخلل في ميزان القوى العربي-الإسرائيلي ما زال قيداً على إمكان التوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة –ولا نقول عادلة- في الصراع وأن ثمة جهداً فائقاً ينبغي بذله لتصحيح ذلك الخلل من خلال استمرار مقاومة الاحتلال وتصعيدها غير أن المعضلة العربية عامة والفلسطينية خاصة تشير إلى أن هذه المقاومة تواجه في الوقت الراهن ومنذ عدة سنوات صعوبات هائلة على النحو الذي يمثل قيداً واضحاً على إنجازاتها وهو ما ينقلنا إلى الملاحظة التالية. تشير هذه الملاحظة الثالثة إلى أن المقاومة العربية في الصراع مع إسرائيل تواجه صعوبات على كافة الأصعدة على النحو التالي. فعلى الصعيد العالمي نجحت إسرائيل في أن تستغل توجهات إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن وبالذات في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001 في أن تقنع هذه الإدارة بأن ثمة تطابقاً بين حربها العالمية على الإرهاب وبين حرب إسرائيل على المقاومة الفلسطينية، وبالتالي تبنت هذه الإدارة من المواقف ما عقد الأمور كثيراً بالنسبة للمقاومة ووصل إلى ذورة جديدة في الانحياز إلى إسرائيل ودعمها، وهكذا أصبحت الإدارة الأمريكية ترى أن السلام في الشرق الأوسط مرتهن بيد حفنة من الإرهابيين (خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في يونيو2002)، وبالتالي فإنه يبدأ بالقضاء عليهم (وليس بتغيير سياسة الاحتلال الإسرائيلي أو حتى تعديلها)، وأصبح الرئيس جورج بوش نفسه لا يرى أن عودة اللاجئين إلى وطنهم أمر عملي وكذلك الحال بالنسبة لتفكيك الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية (المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون في أبريل2004) كما أخذ يؤكد علينا –وبصفة خاصة في سنتي2007 و2008 دعمه لمبدأ يهودية الدولة الإسرائيلية بكل ما ينطوي عليه من تداعيات فادحة. وعلى الصعيد الإقليمي تراجع التأييد العربي للمقاومة الفلسطينية على نحو لافت، ويبدو معقولاً أن مرد هذا التراجع إلى عاملين أحدهما ذاتي والآخر خارجي، أما العامل الذاتي فهو انفضاض عدد من الدول العربية من حول المقاومة الفلسطينية في أعقاب رهانها الخاسر على صدام حسين إبان احتلاله للكويت في1990، وأما العامل الخارجي فهو تأثر الحسابات العربية بالموقف الأمريكي من المقاومة السابق الإشارة إليه. وهكذا تحول النظام العربي الرسمي من المبادرة بتأسيس المقاومة الفلسطينية وتبنيها (كما في قمتي القاهرة والإسكندرية في1964) وحمايتها من مخاطر الصدام مع الدول التي تعمل على أراضيها (كما في قمة القاهرة1970) إلى الاكتفاء بدعمها لفظياً واقتصادياً (كما في القمم التي عقدت في أعقاب انتفاضة الحجارة1987 وانتفاضة الأقصى2000) إلى المشاركة في حصارها كما هو الحال منذ عام2006 بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية في مطلع تلك السنة. ويلاحظ أن الدعم الإيراني للمقاومة اللبنانية والفلسطينية قد تبلور في إطار هذا الفراغ الذي نجم عن تخلي النظام العربي عن المقاومة. وعلى الصعيد الفلسطيني وقعت المقاومة في الشرك الذي نصبته لها اتفاقيات أوسلو1993 بقبولها –أي المقاومة- فكرة تأسيس سلطة في ظل الاحتلال، وعن طريق هذا القبول تم تحييد أهم فصائل المقاومة الفلسطينية في حينه وهي حركة فتح التي تحولت من قوة مقاومة ضد إسرائيل إلى شرطة محلية تقف بينها وبين الشعب الفلسطيني ناهيك عن آثار انغماسها في "الحكم" ومغانمه. وفي البدء نأت "حماس" –أهم فصيل مقاوم بعد فتح- بنفسها عن المشاركة في لعبة أوسلو، غير أنها غيرت توجهها الاستراتيجي عندما قررت خوض الانتخابات التشريعية في مطلع2006، وبفوز حماس بهذه الانتخابات انضمت إلى شقيقتها فتح في ابتلاع طعم السلطة الذي يتناقض مع منطق حركات التحرر الوطني القائم على الكر والفر، فأصبح لحماس قوات رسمية يمكن تدميرها بصواريخ إسرائيلية وقيادات علنية يمكن اغتيالها. وهكذا تراجع الأداء المقاوم لحماس، وزادت الأمور سوءاً بالحصار الذي فرض على حماس من قبل فتح بقيادة رئيس السلطة الوطنية المنتمي إليها، وهو الأمر الذي وصل إلى الصدام المسلح الكامل بين الحركتين في يونيو2007 والذي وصل بالمقاومة الفلسطينية إلى أخطر مراحلها، وبانشغال فصيليها الرئيسيين بترسيخ وجود كل منهما على الأرض التي يقف عليها في مواجهة شقيقه مما يمكن تصور تأثيره الفادح على "فعل المقاومة" وإمكانات التسوية معاً، فالمقاومة تخسر بداهة ولو جزءاً من إمكاناتها بسبب هذا الصدام، وعملية التسوية مستحيلة في ظل وجود رأس للسلطة الفلسطينية لا يسيطر على كافة أراضي ما يسمى بالحكم الذاتي الفلسطيني. وعلى الصعيد الفكري تواجه المقاومة بأنصار "ثقافة الخنوع" الذين لا يفتأون يؤكدون على أن طريقها مسدود وأن جريمتها في حق شعبها لا تغتفر، أو أنها بأعمالها غير الناضجة (كإطلاق الصواريخ على سبيل المثال) لا تتسبب إلا في مزيد من العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وهذا المنطق مردود أولاً لأن النهج البديل (أي التسوية) عقيم وسيبقى كذلك دون ممارسة فعل مقاوم حقيقي وثانياً لأن تاريخ المشروع الصهيوني على أرض فلسطين –كأي مشروع استعماري- يشير إلى أن العنف المفرط سمة من سمات الاستعمار، وهل يمكن على سبيل المثال أن نقارن العنف الإسرائيلي الحالي الذس يرده أنصار ثقافة الخنوع إلى إطلاق الصواريخ الفلسطينية بالعنف الذي مورس ضد الشعب الفلسطيني لحظة نشأة دولة إسرائيل وفي أعقابها على سبيل المثال. ختام: هكذا تبدو معضلة المقاومة/التسوية في الوضع العربي في سياق الصراع مع إسرائيل، فالتسوية مستحيلة لأن ثمة خللاً بنيوياً في ميزان القوى العربي-الإسرائيلي يجعل دولة الاحتلال في غير عجلة من أمرها لإنجاز تسوية، والمقاومة تواجه صعوبات هائلة بسبب المتغيرات التي أشير إليها في السابق، ولكي يصل العرب الفلسطينيون إلى تسوية متوازنة فإن ثمة جهداً خارقاً يتعين عليهم بذله يبدأ بإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتخلص من أوهام أوسلو (السلطة الوطنية في ظل الاحتلال)، والتفرغ بدلاً من ذلك لمهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية في ظل المتغيرات الجديدة، فليس معقولاً أن تكون المنظمة وفقاً لقرار القمة العربية في الرباط في1974 هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني دون أن يكون فيها تمثيل لحماس، فإذا نجح الفلسطينيون والعرب في مهمة إعادة البناء هذه أصبح بمقدورهم أن يديروا حواراً حول الاستراتيجية المثلى للنضال مع إسرائيل والتي يجب أن تتبنى رؤية واضحة ومتماسكة لإدارة الصراع وتحدد أدوات النضال لتحقيق هذه الرؤية بدءاً بالعمل الدبلوماسي والإعلامي ومروراً بالمقاطعة الاقتصادية والعصيان المدني وانتهاءً بالنضال المسلح، وعلى الظهير العربي للمقاومة أن يدرك أن نكوصه عن دعم هذه المهام المطلوبة لن يكون له من نتيجة سوى زيادة الاختراق الإيراني والأمريكي للنظام العربي طالما أنه يتواني عن الوفاء بمهامه الأساسية.
| |||||||
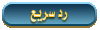 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |

 فقدت كلمة المرور؟
فقدت كلمة المرور؟ فقدت إسم العضوية؟
فقدت إسم العضوية؟