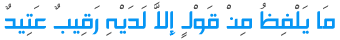وليد سامي أبو الخير
بينما فولتير يرقد على فراش الموت حضر إليه رجل الدين يطالبه بالاعتراف بالذنب حتى يطلب له الغفران، هو حريص كل الحرص على ألا يموت هذا الفيلسوف إلا وقد خرجت كلمة الخطيئة من فمه لينعش بها خطاباً آثماً بات يندثر، أما فيلسوفنا فقد ردّ عليه بكل أناة وحلم رافضاً أن يدلي بكلمة واحدة ترضي الروح الشريرة، وقتئذ صرخ رجل الكهنوت بصوته عاليا يروم إسماعه المتجمعين حول فولتير: «لقد أتيتك من عند الله» ابتسم الفيلسوف في مرقده الأخير وقال بصوت متهدج: «كلكم تدعون ذلك، أرني من فضلك أوراق اعتمادك».
مات فولتير وعاشت ثقافة التسامح، وغدا كتابه دستوراً يُمنهج ويُدرس، وتداعت الفلسفات من بعده تحيي دعاويه وتميت دعاوى التخندق الانتمائي، ألم يصبح شعار فلاسفة فرنسا: «أن تفهم الفلسفة عليك أن تعود إلى الإنسان في درجة الصفر» لقد أصبح الفيلسوف فيلسوفاً فيما بعد يوم أن طبق تماماً حذافير نصيحة فولتير: «من لم يعش هموم عصره اجتمعت فيه كل شروره» وغدت الفلسفة لاحقاً تلتفت نحو الإنسان العاري الجائع، البسيط في تجلياته، البعيد كل البعد عن الاحترابات الإثنية البينية، المتسامح بأصل خلقته، المتعالي عن الكره والإكراه، أما ذاك المنقلب على أصل الفطرة، المتحاذق، فحاله كحال الصوص لا يرى العالم الخارجي بفسحته لأنه حبيس البيضة الضيقة التي يتخلّق فيها، ولذا هو يرى العالم كله ضيقاً، ويزداد في ضيقه وينتفخ خطابه حتى ليكاد يدعو الناس إليه، وإن رام يوماً أن يبصر النور والحياة لزم عليه أن يثقب قشر البيضة بمنقاره، حينها إما أن يعيش مع أول دفقة نور، وإما أن يموت لأنه لم يعتد العيش إلا في الظلام، وما أسوأها وأحلكها من ظلمة تلك التي تتزمّل بخطاب مفتئت على الشريعة مدعٍ عليها.
إن الإسلام متجلياً في آيات الكتاب الحكيم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك احترامه إرادة الإنسان، جنس الإنسان، وبالتالي احترام وجوده، واحترام مرتبات هذا الوجود من اعتناق ديانة أو إيمان بمعتقد، سواء أكان ذاك الإنسان الذي هو هنا بمعنى الآخر فرداً أو جماعة، متخفياً بمعتقده أو معلناً له، ويكفينا عضداً في ذلك قوله تعالى آمراً نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الكافرون أن يقول: {لكم دينكم ولي دين} مع أن الدين عند الله جلّ في علاه هو الإسلام كما ورد في سورة آل عمران، إلا أن الآية التي ذكرنا قبل سمّت معتقدات الآخر ديناً بناء على ما يعتقده هو من كونها دينا، في تجلٍ بهي لمعنى المسامحة والتسامح، وأن اختلافنا الديني لا يعني أبداً اختلافنا الإنساني، بمعنى الاختلاف حول إحقاق الحقوق وحفظها، فالآدمي من حيث هو آدمي مكرم {ولقد كرمنا بني آدم} وإذا كان الإكرام ملتصقاً بالذوات فكيف بالله عليكم يكون منفكاً عن ما هو ملازم لهذه الذوات من اعتقادات وممارسات؟ أليس في هذا تناقض صارخ؟ أن تحترم ذات المرء ولا تحترم معتقده؟ ألم يقم النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت بجنبه، فلما سئل عن فعله ذلك وأنها جنازة يهودي، أجاب: «أليست نفساً» كما ورد في الصحيحين، أليسوا من نختلف معهم وننتقص منهم ذوي نفوس؟ ويا للعجب لقد قام النبي الكريم في جنازة يهودي ميت.
واليوم من يدعي اتباعه ينتقص مزدرياً من القريب الحي؟ سبحانك ربي، لا تفسير عندي إلا أن الفهوم لم تستوعب بعد مفاهيم دينها الحنيف السمح، إن من آذى أو انتقص أو استهزأ مخالفاً له في المعتقد لمجرد مخالفته هو بذلك آثم، ما لم يجتنب ما نهى الله عنه وزجر، (وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) رواه مسلم، إن الله ينهانا عن ما يظنه البعض اليوم واجباً دينياً والتزاماً شرعياً، ينهانا أن نأتي على ذكر معتقدات الناس بالنقيصة والازدراء لاسيما في قبالتهم، ينهانا أن نحتقر وأن نقلل من شأن كرامة الآدمي، (كلكم من آدم) رواه أحمد، وفي هذا نجد كلاما نفيساً للطاهر بن عاشور يقرر فيه معنى المساواة المكتسبة من أصول التشريع، حق الوجود المعبّر عنه بحفظ النفس وحفظ النسب، وحق المساواة في وسائل الحياة المعبّر عنها بحفظ المال، وحق حفظ أسباب البقاء على حالة نافعة المعبّر عنها بحفظ العقل والعرض، وأعظم من ذلك كله حق الانتساب إلى المعتقد، المعبّر عنه بحفظ الدين، والوارد في الآية باعتبار طقوسه المؤداة، إنها الحقوق المقررة بقوله عليه الصلاة والسلام: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، ولو تعامل الإنسان بملء هذه القاعدة لاختفى من قلبه كل حقد انتمائي، ذاك أنه يتعامل بما يروم من الآخر أن يتعامل معه، وهذا هو مقصد الحديث تماماً


 الخميس 27 أغسطس - 21:40:08
الخميس 27 أغسطس - 21:40:08
 موضوع: هـــــــــــــــااام جدا !!!! ~×~ طريقة جديدة لسرقة العضوايات ~×~ متجدد ~×~
موضوع: هـــــــــــــــااام جدا !!!! ~×~ طريقة جديدة لسرقة العضوايات ~×~ متجدد ~×~
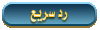

 فقدت كلمة المرور؟
فقدت كلمة المرور؟ فقدت إسم العضوية؟
فقدت إسم العضوية؟