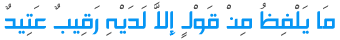ذاكرة اليهود في الرواية التونسية: المقاصد البعيدة؟؟؟؟؟؟؟
- اقتباس :
ذاكرة اليهود في الرواية التونسية
رواية "حنة" للرّوائي محمّد الباردي نموذجا.
لقد اعتدنا أن ينهض اليهود لتدوين ذاكرتهم بآليات حجاجية تروم جني الإشفاق من ناحية ودفع الشبهة من ناحية أخرى، وذلك بالتقاف اللحظة التي تتكثف فيها إنسانية الإنسان، لكننا شهدنا في الآونة الآخيرة من نهض من العرب لتدوين تلك الذاكرة اليهودية، محملا بمقاصد بعضها بيّن وبعضها الآخر يحتاج منا إلى تشريح حتى نلج إلى ما ووري الهمس.
ومن هذا المنطلق كانت هذه الأوراق التي تنظر في رواية 1"حنة" للروائي التونسي محمد الباردي.
تقع رواية "حنة" في 268 صفحة وقد كتبت في جنس السيرة الروائية أو رواية السيرة الذاتية، ولا ينكر المرء ما في الرواية من جهد فنّي وجمال مأتاه سرد التفاصيل الحميمية وزانه البعد الواقعي الاشتراكي، ولكن هذه الفتنة تفتر إزاء المواقف الحضارية المبطنة حتى تضمحل تاركة وراءها حيرة واستنكارا.
فقد شاء الكاتب تحويل النص من سيرة الذات إلى سيرة لليهود، إذ عمل على
توشيح روايته بذكر أخبارهم منذ ص 41 إلى حدود ص 226 بفقرات مختلفة الطول متفاوتة التواتر، وإن يكن بعض هذه الفقرات مشروعا بحكم معايشة الكاتب له فإن بعضها يفتقر إلى الشرعية بحكم عدم مواكبة الكاتب لأطواره وهو ما يدعونا إلى الاستفهام حول جدوى ما كتبه: فلماذا تدوين ذاكرة اليهود اليوم بأقلام عربية؟ ما غاية الكاتب من إقحام شخصيات يهودية؟ وإلى أي حد يعتبر ولوج الذاكرة اليهودية التونسية بريئا؟
ننبّه منذ البداية إلى أننا لسنا ضد اليهود ولسنا دعاة حرب على اليهودية، ولا ضد الطائفة اليهودية التي تمثل أقلية في تونس، لكننا ضد تزييف الحقائق وضد خلق فجوة بين المواطنين بتفضيل بعض على بعض، كما أننا ضد زرع الفتنة والتعدي على ذاكرة النضال الوطني.
ولقد اتخذت في الكشف عن تلك الذاكرة والإجابة عن الأسئلة السالفة منهجية تتبع نموّ الأخبار المتعلقة باليهود، فكانت خطية حينا عمودية حينا آخر لأنها إذ تعثر على البؤرة تكرّ على متعلقاتها
التي قد ترد مجاورة أو بعيدة، وفي ظننا أن كل خبر هو لبنة وكل ذكرى هي درجة في بناء ـــــــــــــــــــــــــ
1) رواية "حنة" محمد الباردي مركز الرواية العربية، 2010 تونس
مشروع لموقف معين:
1) البداية: في البدء إشعار بتوتر الأجواء عقب النكبة التي لا ترد اسما ولكن يكتفي الكاتب من المأساة بالإطلالة على ضيق الأجواء وكثرة العسس والحرس(العساكر منتشرون في الشوارع وشاحنات الجيش رابضة في الرحبة)ص 41 وقد لمح بذلك إلى الحدث الأبرز الذي عمد إلى تقسيطه على فترات حتى يبقي على جذوة التشويق متقدة، و سيأتي بيان الحدث في الخاتمة لكنه اكتفى في البداية بتصوير مظاهر التوتر والرعب التي يشهدها المواطنون إثر كل عملية تنجز ضد فرنسا. و يحافظ الكاتب على ضبابية من ينجز هذه الأعمال كما لا يرتقي بها في الحدث ولا يهبها ما هي أهل له من الهيبة والإجلال، فكل ما يتصل بالاستقلال بارد، مائع، لا طعم له يضيع في التفاصيل الأخرى. وما كنا لنلوم كاتبا على إهمال تلك التفاصيل التي يفترض حدوثها في سنه المبكرة جدا لولا إصراره على سرد سيرة اليهود بذاكرة الفيلة ما الغاية إذن من تغييب المناضل واستحضار سيرة اليهود في حياته حتى عاد المناضل غريبا، والغريب حاضرا؟ هو سؤال نعول أيضا على بقية الصفحات لتجلوه.
2) إذابة الجليد: نهض الظهور اليهودي الثاني بدور إذابة الجليد بين العربي و اليهودي وإزاحة الحاجز الذي يمنع التقرب إلى اليهودي وما كان ذلك ليتم إلا بتهشيم تمثلات الوعي الجمعي المتعلق بحارة اليهود (كانت أمي توصيني بالابتعاد عنها وكانت تقول أيضا الحارة نتنة وطعام اليهود نتن وثيابهم نتنة)ص 47 وسيسهم هذا الكسر في تقبل العالم المختلف (اليهودي) كجزء من الوعي وبارقة جمال في كتل القبح و الفقر. وما هي إلا خطوة واحدة حتى يدرك أن ما ترسّب في المخيال هو محض خيال(لم أجد ما يبرر كلام أمي وموقفها وأنا أشم رائحة العطور المنبعثة من أجساد النساء وأثوابهن)ص 47 إنها المرة الوحيدة التي تظهر فيها الأم مخطئة لأنها في باقي الرواية امرأة تحافظ على حكمتها ورجاحة عقلها، ففيم جنوح الكاتب بصورة الأم إلى تشويه صورة اليهود الجميلة؟ يشرع الكاتب إذن في رحلة الاسترجاع في خطاطة حجاجية واضحة هدفها تفنيد مقولة خاطئة ورأيا ظالما يتهم اليهود بالقبح "النتن"، كأنما من أهداف هذه السيرة الروائية أن تدافع عن الحضور اليهودي، وها يندب نفسه لتلميع الصورة التي يرى أنها تشوهت في المخيال المشترك بفعل عنصريّ ما، كأنما يذكّر بالمظالم العديدة التي لحقت اليهود في العالم.
3) الافتتان بعالم اليهود: وتنضاف إلى بناء التواصل لبنة جديدة فلا يكتفي الكاتب "المتسامح" بإيلاج الغريب مجال البداهة بل يتحوّل الموقف سريعا إلى فتنة وانبهار(لم أر سيقانا بيضاء كتلك التي رأيتها ذلك اليوم...لباسهن وزينتهن يوم الزيارة أضفيا عليهن جمالا لم تره عيني) ص 47 وبسرعة يكبر الافتتان ليصبح الآخر اليهودي مصدرا قارا من مصادر اللذة والجمال و الحب العفويّ.
وقد أسهمت في نمو هذا افتتان الطفلة اليهودية (سارة) التي صارت مصدرا مضافا من مصادر تأثيث الصورة الجمالية الطفولية(أما أنا فكنت أرتاح إلى سارة كانت أصغر مني قليلا ولكنها كانت تتكلم الفرنسية فقد كانت تذهب إلى الماترنال في سنها المبكرة ولذلك تطعم لهجتها التونسية بكلمات وعبارات فرنسية وكانت تقول أناشيد وقصائد)ص 51
ولم ينس في أعطاف كل ذلك أن يشيد بكرم اليهود يخرجون بسلال البيض لتوزيعها هبة على الصبية من أبناء المسلمين( ولكن رجلا ملتحيا خرج من دار الصلاة يحمل قفة تحوي بيضا مسلوقا اتجه نحونا ودعانا إليه) ص 48 ولا أدري أكانت مصادفة أم أمرا مخططا أن يذّكر كرمهم في هذه الصفحة بالذات (48) مع ما ندرك من رمزية لهذا العدد المحيل إلى اغتصابهم الأرض و تأسيس الكيان الصهيوني. ولعلّي لا أخطئ الصواب إذا قلت إنه الأثر الأول الذي يجترئ للحديث عن كرم اليهود، إذ ترسخ في الوجدان العالمي بخلهم ولنذكر في ذلك شخصية التاجر اليهودي في مسرحية "تاجر البندقية"، ولنذكر أيضا أن كثيرا من الآرزاق التونسية و الأراضي ماتتكما لا ينسى المواطنون التونسيون ضياع كثير من أرزاقهم وأراضيهم بسبب تراكم ديون الربا، إذ لم يكن اليهود يقرضون المال إلا ربا.
كما أسهمت في تأثيث هذا الافتتان الراقصة اليهودية (جودة) التي ارتبطت بالحوذي و ألهبت عيون شبان الحي و أثارت غيرة النساء في الرحبة بأناقتها وحسنها (كانت تمشي متهادية توزع بسماتها على اليمين والشمال وكنا نحن أبناء الشارع نمشي وراءها نتنشق رائحة العطر التي تتركها وهي تمشي)ص 60 ورغم أن اللقاء لم يكن معها مباشرا ورغم أن ذكرها لم يتصل إلا بالحوذي ومن عرفوها من الراشدين، يصر هذا الرّاوي الطفل على ذكرها وتتبع أخبارها خاضعا بذلك إلى جبرية الرّواي الراشد الذي أنشأ السرد بحسابات دقيقة.
وتعتبر أقوى مشاهد الافتتان تلك المتصلة بالليبيدو فيسافر بنا الرواي إلى أدق تفاصيل حياته المراهقة، هناك في خلوته الليلية يحلم بالجسد فلا تمثل أمامه صورة "جنات" المغرية ولا صورة قريبته التي "ركبها في الصاباط" ولا أيّ من الصور العربية، يقرر الكاتب الراشد أن يقحم الراوي الطفل في تجربة الاستمناء واجتهد في تعريتها ووصفها بدقة متناهية واختار لموضوعها صورة "يهودية حسناء" متجهة إلى الكنيس للصلاة، ويبدو أن اللحم العربي المتاح و التجارب العربية التي عرف خلالها الجسد لم ترض شهوته ولم تشبع نهمه فاصطنع للعبته المراهقة صورة أخرى ألذّ (تظل صورة اليهودية الشابة وهي في فستانها الضيق الذي يحوي مفاتنها تطاردني في الليل كله...تتوالى الليالي التي أرى فيها اليهودية الجميلة أرسم بمخيلتي صورة الجسد...ثم أشرع في مداعبة نفسي ...إلى أن تدكني لذة القذف) ص 163. هكذا تصبح هذه اليهودية مصدرا للذة المتخيلة، لذة غير مبررة سرديا، لأن المشاهد الحقيقية التي عرف فيها الرّواي الجسد كان موضوعها الجسد الأنثوي العربي، فلم يعدل عن الصورة الأوضح إلى الغيم؟ ولم يفتتن بالجسد اليهودي و العربي متاح؟ وقد سبق له أن رأى جسد الفتاة الغريبة عارية كما سبق له أن شاهد ثدي جنات وفخذيها...؟ لقد كان له من رصيد الجسد العربي ما يؤثث جلسة الاستمناء لكنه يعدل عن كل ذلك ويختار من الصور أقلها وضوحا و إثارة و أكثرها شبهة مدفوعا بفتنة العنصر اليهودي مأخوذا بجمالية مختلفة المذاق، إن ما نخشاه هنا هو أن يكون هذا الافتتان ترجمة لموقف حضاري مغترب يرى في الآخر حلاّ لجميع المشاكل بدءا بمشاكل الليبيدو التي كانت من أدوات الكاتب لا يتخلّى عنها.
4) المقارنة الموجعة: يشعرنا الكاتب كلما تحدّث عن اليهود بأسفه ووجعه الدائم لأنه يجد نفسه في كل مرة في سياق مقارنة بين العالم اليهودي والعالم العربي المسلم يقول (كانت حكايات الصغيرة سارة تثير في نفسي وجعا كبيرا لأنني كنت اذهب إلى الكتاب في جامع سيدي إدريس وكان المؤدب شيخا طاعنا في السن ولكنه كان لا يزال قادرا على الإمساك بعصا طويلة)ص 51 ، هي في الحقيقة مقارنة لكنها تفضي إلى مفاضلة، فقد أشاد الكاتب بأناقة اليهودي مقابل إهمال العربي، وركز على رهافة حس اليهود مقابل صلف العرب، حتى في ما اتصل بالمأكل( ويقول أبي أيضا اليهود يحبون الماعز وكل الفلاحين في الحيّ يربون الماعز لليهود، نحن لا نشرب الحليب إلا عند المرض ولا نأكل اللحم إلا في عيد الفطر ...ولكن اليهود وحدهم كانوا يشربون الحليب ويأكلون اللحم) ص 49 ، ثمة إذن إصرار على بخس حظ العربي من الجمال مقابل الارتقاء بصورة اليهودي فعاد بذلك رمزا للتأنق في الحديث والملبس والمأكل والمعاش، في حين يسيطر فعل الرداءة على عموم الشخصيات العربية الحاضرة فبائع الكاز يبني علاقة جنسية مشبوهة بزوجة أبيه، و"العم علي" صاحب الجنية المزعومة يبني علاقة جنسية مع الجارة جنات، وحتى الأب لا يسلم من هذه الانهيار القيمي في هذا الوقت يقرر الراوي قتل الأب كمصدر للأخلاق والقيم فها هو ينصاع إلى فعل الغريزة مدفوعا بإغراء جنات (وضعت قدمها على قدمه...بعيني المفتوحة لاحظت ارتباك أبي..التفت إلى أمي التي أخذها النوم مع طفلها، اطمأن، عندئذ أعادت الحركة ذاتها، ويا لها من مفاجأة أبي يضع يده على فخذها...لم أعد أشك الآن في العلاقة التي أصبحت تجمع أبي بجارتنا)ص 85، وكأننا لسنا في عالم عربي مسلم تسيطر الرذيلة وتضيع الطقوس الدينية اللهم إلا أن تكون بعض الطقوس الفولكلورية المرتبطة بزيارة الأولياء الصالحين ولكن هذه أيضا مشوبة بالحوار الجسدي منتهية إلى الخطيئة، في هذه الأجواء العربية المترعة رذيلة تنبثق صورة اليهودي المتأنّق المتعفّف المتديّن الذي لا يفرط في زيارة الكنيس رأس كل أسبوع.
ثمة في النص هندسة فنية واضحة في ما تعلق بأمر اليهود فكل موضع محسوب وكل حدث منضبط وفق خطاطة حجاجية واضحة، فبعد أن برّأ اليهود من شبهة الرائحة النتنة عاد في آخر النص بأطروحة مضادة يؤكد فيها أن الرائحة الكريهة الحقيقية إنما مأتاها قذارات العرب المتراكمة في ساباطاتهم وجوانب دورهم(عندما أدخل إلى السّاباط الأول أضع كفي على فأنفي، و أكتم نفسي إلى أن أخرج منه)ص242 وبهذا أيضا يبني الكاتب مقارنة بعيدة الطرفين شقها الأول في الصفحات الأولى وشقها الثاني في الصفحات الأخيرة وكعهده بالمقارنات تنتهي هذه أيضا إلى مفاضلة تنتصر لليهودي!!! وتأتلف هذه المقارنات لتصنع موقفا مغتربا يبخس حظ الذات ويعلي من شأن الآخر، اغتراب يصنعه استرجاع مفاصل الحياة ومفردات الحياة اليومية فإذا الرواي مأخوذ باليهودي والغربي يستقبل لذائذهما بكثير من الحفواة ويضحي العربي أو المسلم مصدرا للأسى والقبح، وتضحي متعلقات العربي كناية واضحة عن البشاعة، فلا يسلم جماد ولا حيوان من هذا الفعل المقارن، ويطفو هذا الاغتراب على سطح الخطاب بطريقة عفوية أو مدبرة خلال مقارنة حيواناتهم بحيواناتنا، يقول السّماك متحدثا عن كلبه الجديد البديل عن الكلب السابق الذي سرقه الأولاد وأكلوه(انظروا إليه. هذا ليس "كلب عربي" جبانا تأكلونه في الواحات إنه "بارجي" ألماني، سيبتلعكم إن دخلتم السّاباط ومررتم أمام البيت) ص 245 . ويجب أن أعترف هنا أن لهجة الاغتراب تصيب من يقرأ بكثر من الإنكار والتقزز. فإلى أين يسير بنا كاتب يكتب ذاكرة غيره ويغرق في التفاصيل اليومية والخاصة لتشويه كل جميل؟
5) تزييف التاريخ: من المستفيد من افتعال "هولوكوست" آخر؟
تنتهي سيرورة الأحداث المتصلة باليهود في ص 226 أي أواخر الرّواية وبذلك ضمن الكاتب انتشار هذه الذاكرة في مفاصل السّيرة الذاتية وليس ذلك بغريب عن كاتب يعتبر اليهود جزءا من تاريخه (عندما قام الحي الجديد لم أر حارة اليهود...لقد كنسوا جزءا من تاريخي) ص 164.
في هذا الفصل يفاجئنا الرواي بافتعال فاجعة أليمة تتمثل في هجوم بعض المجرمين على حارة اليهود ذبحا وسرقة لم يتورّع عن وصفها بالمذبحة في مناسبات ثلاث(يمسكون برقاب أهل الدار ليكشفوا عن سر الذهب و الفضة وعندما لا يجدون يذبحون من راق لهم ويخرجون)ص224 (عند الفجر انتهت المذبحة)ص 225 كما يؤكد هذا اللفظ في موقع آخر (الرجال الذين دخلوا الحارة وذبحوا رجالها ونساءها) ص225 إنها بلا شكّ كلمة كفيلة بأن تضيف إلى ذاكرة اليهود "هولوكوست" جديدا يرسخ تاريخ الظلم ويكرّس ما يسمى بمعاناة اليهود في الوجدان العالمي فحيثما حلّ اليهود تلقفتهم الشعوب بالقتل والترويع. وبنفس الآلة الإعلامية الصهيونية التي تستجلب الإشفاق، سارت تقانة السرد في رواية "حنة" تصطنع ما لم يوجد وتفتعل ما لم يحدث، وتوغل في صنع المأساة اليهودية، وتنبثق إذّاك صورة "سارة" البنية اليهودية من جديد، وقد فقد بريقها وراح ألقها وانقلبت سعادتها إلى بؤس جنائزي فقد فجعها المجرمون في أمها و أبيها أمامها!!!!! (البنيّة سارّة التي لعبت معها...وحدثتني عن معلمتها، وعن حياتها في المدرسة، التفتت. وضعت كفيها على وجهها. هل كانت تبكي وهي تتعرف على الرجال الذين قتلوا أباها و أمها أمامها؟)ص223، ويجب أن التأكيد هنا أن خللا كبيرا يعتور منطق المحرقة الجديدة ويتهدد بناءها السردي و التاريخي بالانهيار فمن أسباب هذا الخلل:
أ. أن عمر الرواي لا يسمح بالحكم على الأحداث فهو من مواليد سنة 1947 والهولوكوست المزعوم وقع على خلفية النكبة 1948 (المصيبة التي حلت بالعرب ..كانت كبيرة..ذهب رجال إلى هناك ورأوا الكارثة بأعينهم ثم عادوا غاظهم أن يروا سكان الحارة بعد أعوام قليلة وهم يشرعون في بيع مساكنهم..لكن الانتقام كان فظيعا) فتبعا لهذا لا يمكن لراو لم يبلغ ولم يحلم أن يستعيد تلك الأحداث بكل هذه الدقة وهو لم يحلم بعد ولم يصل السادسة أصلا.
ب. اضطراب الرواي في تحديد علاقته بالحدث إذ يعنّ له أن يثبت و ينفي في نفس الفقرة (وهو حدث لم أعشه..../هذا الحادث عشته وأنا لا أزال في طفولتي الأولى)ص 221، ويصرّح الكاتب بعجزه عن استرجاع ما حدث لكنه يستعين بالأخبار (ولا أستطيع الآن أن أصف الحادثة كما وقعت، وإنما سأروي ما سمعت)ص 223، لكنه مع ذلك ينسب إلى نفسه بعض الأخبار (ما أذكره بعد ذلك هو أن الجنود ظلوا أسبوعا كاملا يبحثون عن الجناة)ص 225.
ج. تشكيك الكاتب في ناقلي الخبر الذين اعتمد عليهم في التأريخ(لكن لا أعتقد أن أحدا منهم شاهد الرجال وهم يسطون على الحارة ويقتلون عددا من سكانها لكنهم مع ذلك يروون) ص 223، (وهنا تضاربت روايات)ص 224.
د. اضطراب في تحديد الفترة الزمنية التي وقعت فيها الأحداث، فقد وردت المذبحة المزعومة في الفصل 17 وكان قبلها في الفصل 15 قد صرح أنه بلغ الثالثة عشرة (ها أنا أنهي الثالثة عشرة) ص197 لكنه يتحدث أيضا عن وقوعها في طفولته الأولى (هذا الحادث عشته وأنا لا أزال في طفولتي الأولى)ص221 فيكون بذلك دون السادسة، إلا أنه لا يتورع عن ربطها بالهربة (لكن عمتي كانت به تؤرخ لما حدث في حياتها كانت تقول قبل "الهربة" أو بعد "الهربة" وقع كذا) و"الهربة" مصطلح يشير إلى معركة خط مارث وما تلاه سنة 1943 ويكون الراوي في ذلك الوقت دون الولادة أصلا أو دون السادسة حسب التقدير الأقصى.
وهكذا نجد في هذه الرواية من الوهن و الضعف التاريخي و السردي ما يدفعنا إلى التساؤل عن السبب الكامن وراء اصطناع حدث رهيب يسيء إلى التاريخ الوطني من ناحية ويعزز الرواية الصهيونية بأن العالم كله آثم في حق اليهود، وهذا الأمر - شاءه الكاتب أو وقع فيه لقلة نظر- خطير جدّا لأننا إذ نكتب تاريخنا لا نريد أن نسمّ الأجيال اللاحقة بأراجيف يقشعر لها بدن كل وطني غيور، إنه لأمر خطر والأخطر منه أن يعمد الكاتب إلى تشويه صورة الوطنيين المناضلين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن ننعم بالحرية، فمن المضحكات المبكيات أن جعل الكاتب أسلافنا الأحرار مسؤولين عن تلك المذبحة المزعومة التي لم يشهدها ولم تحدث أصلا (إلى أن علموا أنهم ألقوا القبض على الفلاّقة هكذا أطلق الناس على هؤلاء الرجال الذين دخلوا الحارة وذبحوا رجالها ونساءها) ص225.
هكذا حضرت الذاكرة اليهودية في رواية "حنة" للروائي التونسي حضورا طاغيا في مفاصل النص كله، في مخطط حجاجي ينشئ المقارنة فيفضل اليهودي العربي، بما اختزل من وهج الكرم و التأنق و الفتنة، ثم إذا العنصر اليهودي الذي انبثق رمزا لكل جميل يندثر بعد مذبحة مزعومة وفر لها الكاتب كل مقومات التأثير من أدبيات الهولوكوست حتى لكأنّ ما حدث في ألمانيا النازية يتكرر في (قابس) المدينة الآمنة التي تعرف سنويا إقبال اليهود للزيارة وربط الصلة مع المواطنين.
ويظل السؤال قائما فعلا: لم يجتهد الكاتب وهو يدون سيرته الذاتية في افتعال أحداث ضعيفة السند واهية الرواية قد بلغت الذروة من الخطورة؟ هل كان عليه وهو يتحدث عن حياته التي عاشها أن يقحم فيها ما لم يعشه؟ أمامنا هنا كاتب لم يشهد المذبحة ولكنه مصر على السّرد (وهو حدث لم أعشه ) ص 221، (ولا أستطيع الآن أن أصف الحادثة كما وقعت، وإنما سأروي ما سمعت)ص 223، وهو منطق لا يختلف كثيرا عن الشعار الذي ترفعه مواقع الهولوكوست: (بالنسبة لي, المحرقة هي جزء من سيرة حياتي, حتى أنني لم أكن هناك وعائلتي كذلك لم تكن هناك. وتقع على عاتقي المسؤولية أن أذكر ذلك, ليس لأنال الرحمة من أحد, بل لأتحمل المسؤولية عن نفسي وعن شعبي) المصدر: (http://www.theelders.org/ar/article/yad-vashem-message)
وبعيدا عن جمالية الفن، وصناعة التشويق، ينفتح هنا سجال أكيد حول مسؤولية المثقف وأبعاده الرّساليّة، فليس من المقبول أخلاقيا ولا تاريخيا أن نضيف إلى انتصارات الصهيونية العالمية انتصارا إعلاميّا آخر بأيدينا، ولا أجد مبررا واحدا يدفع كاتبا راشدا معروفا على الساحة العربية إلى افتعال مذبحة جديدة واصطناع مأساة يهودية لم تقع، ولو نبش أستاذنا الجليل لوجد في ذاكرته وذاكرة المحيطين به من ينعش الملفات الرّاكدة، ففي صدور الرجال بمدينتي ومدينته (قابس) ما يملأ آلاف الصفحات عن رجال شاركوا العرب نكبتهم ونكستهم ونضالهم في بيروت، وأشدّ ما أخشاه أن تكون هذه الرواية التي كتبت قبل الثورة صدى لموجة سياسة معروفة بالتطبيع الثقافي. نخشى أن تعمى الأعين عن الظلم الواقع و أن يشذ القلم عن السقف المطلوب من الوعي أو تقصر به الهموم الشخصية عن إدراك شرف الرسالة التاريخية فيسقط في مرذول المقاصد أو تجفف حبره المناصبُ الزائفة أو حلم بمصافحة جائزة عالميّة صرنا نعلم ثمنها.
منير الرّقي تونس.


 الأربعاء 15 أبريل - 21:22:25
الأربعاء 15 أبريل - 21:22:25
 موضوع: ذاكرة اليهود في الرواية التونسية: المقاصد البعيدة؟؟؟؟؟؟؟
موضوع: ذاكرة اليهود في الرواية التونسية: المقاصد البعيدة؟؟؟؟؟؟؟
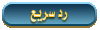

 فقدت كلمة المرور؟
فقدت كلمة المرور؟ فقدت إسم العضوية؟
فقدت إسم العضوية؟