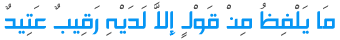| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
|  |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
 السبت 4 أكتوبر - 10:14:30 السبت 4 أكتوبر - 10:14:30 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط 
|  موضوع: الشعر الفلسطيني في خمسين سنة 1917-1967 موضوع: الشعر الفلسطيني في خمسين سنة 1917-1967 الشعر الفلسطيني في خمسين سنة 1917-1967 الشعر الفلسطيني في خمسين سنة 1917-1967 يوسف سامي اليوسف أولاً ـ تمهيد ها قد صار ناصعاً تمام النصوع أن الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل، آخذ بصياغة تحديداته التاريخية، أو هويته الذاتية التي تميزه عما سواه من شعوب الدنيا، وذلك عبر الصدام الملحمي الذي يخوضه ضد الآخر كل يوم، منذ مائة سنة أو زهاء ذلك ففي صلب الحق أن هذا الشعب الأعزل إنما ينافح عن الكرامة الإنسانية بوصفها الكلية المطلقة، أو القيمة العليا في الوجود، ضد هذا الوباء الجذامي المستفحل باضطراد، وهو ما أفضل أن أسميه أولئك دون تحديد أو تعيين، إذ ليس لتلك الطفيليات أية هوية كريمة، بل ليس لها سوى كومة من الخزعبلات يشهرها في وجه عالم ساقط شائخ، بل شائه، لكي تتحدث عما تسميه "أرض أجدادها" وتلكم ذريعة جيدة يتذرعون بها لابتزاز ثروات العرب. فمما لا يخفى على الألباء أن اللاعقلانية تفوح من وجودهم الطفيلي الشبيه بوجود الأشنيات، إذ لقد تركوا أوروبا الشرقية، بسهولها الفسيحة وأنهارها الغزيرة ومواسمها الخصيبة، وجاؤوا إلى فلسطين لكي يزاحموا الناس على قفارهم المجدبة ومصادر عطشهم الشحيحة، متذرعين بأنهم قد عادوا إلى أرض أجدادهم المقدسة (أتحداهم أن يبرهنوا على أن لهم أيَّ أجداد من أي نوع كان). ثم ارتكبوا الجريمة الشنيعة الفظيعة التي لا ترتكبها إلا كائنات تحترف اللؤم والخسّة، أي إلا أولئك المجرمون وحدهم، وذلك نظراً لحقدهم على الجنس البشري بأسره، وهو الذي يبتغون أن يزدردوه دون أن يعارضهم أحد قط. وكل من عارضهم فهو مخرب أو إرهابي، أو من صنف معاد للحضارة والإنسانية، كما يزعمون. ومما هو في الصميم من طبع الأشياء، إن جريمة كهذه لا يسمح لها التاريخ بأن تمر دون عقاب صارم شديد، ولو بعد ألف سنة. أما الغيتو الذي استنفروا العالم وحشدوه ابتغاء تأسيسه على ترابنا السليب، فلا يزيد عن كونه بثرة عفنة على جلد التاريخ، ولعل في ميسور أي إبرة أو شوكة تاريخية أن تفقأها مرة واحدة وإلى الأبد. إنه كيان مصطنع تافه لا يساوي قشرة بصلة، ولا خير فيه لهؤلاء ولا لأولئك، إذ لا يخفى على أهل الحضور، الذين لا يصيبهم الإغماء بتاتاً، أن ذلك الغيتو الصهيوني قد جلب لهم من الآلام بقدر ما جلب للعرب، سواء بسواء. *** ومما هو في البداهة أن هذا الصراع الذي لم يحتدم بعد، والذي توحي الوقائع بأنه سوف يطول كثيراً، بل كثيراً جداً، لا بد له من أن يفرز على مدى الأيام مشروعاً ثقافياً شديد الخصوصية، ولعل من شأنه أن ينتج تمايزاً عما سواه من تحديدات، بحيث تصبح الشخصية الفلسطينية مختلفة جد الاختلاف عن بقية الصيغ الاجتماعية والثقافية، لا في المنطقة العربية وحدها، بل في العالم كله. ولن يظل متخلفاً في العقر الفلسطيني سوى البنية السياسية وحدها، أو سوى مؤسساتها المعقومة التي أحلت نزعة الانتهاز محل روح التضحية والفداء. وما دام الأمر كذلك، فإن مما قد يكون وجوباً، أو حاجة ملحة، أن يتجه المثقفون الفلسطينيون نحو استيعاء هذا التمايز الماهوي الذي ينجزه التاريخ سنة إثر سنة، وذلك ابتغاء البدء بتطوير مشروع ثقافي خاص له القدرة على المضي بتحديد الماهية الفلسطينية حتى تصبح أساريرها، أو سماتها الكلية، كياناً شديد النصوع وغزير الحضور، بحيث يصح القول بأن الشعب الذي خسر أرضه (مؤقتاً) لصالح أولئك، قد ربح شخصية أو هوية لم ينجز مثلها أي شعب آخر في تاريخ البشرية بأسره. فشتان بين الشخصية الفلسطينية العثمانية في أوائل القرن العشرين وبين الشخصية الفلسطينية المضرجة بدمائها في أوائل القرن الحادي والعشرين. ومن العبث العابث أن يلجأ المثقفون الفلسطينيون إلى المؤسسات الرسمية ابتغاء تطوير المشروع الثقافي الفلسطيني الصانع للهوية الفلسطينية، أو المعبر عن خصوصية شعب يخوض صراعاً مريراً ضد الغربيين المحتشدين وراء أولئك. ففي سداة الحقيقة ولحمتها أن تلك المؤسسات برمتها، وبجميع أصنافها، لا تزيد عن كونها تجسيداً للأوهان والعاهات والعجز عن الإنجاز والحراك المجدي. وإن لم تكن هذه الحال هي الانحطاط بأم عينه، فماذا عساه أن يكون الانحطاط، يا ترى؟ وللمرء أن يتساءل عن العلاقة التي تربط تلك المؤسسات الخائرة الخاثرة بالشعب الفلسطيني الدينامي، أو المتفوّر بالحركة والبذل والعطاء. بل إن لك أن تسأل هذا السؤال الصريح: هل من صلة بين أُناس الفنادق وأُناس الخنادق؟ *** وأياً ما كان جوهر الشأن، فإن المشروع الثقافي الفلسطيني، وهو ما يحتاج إلى قامات باذخة شاهقة، جوعها في رؤوسها، وليس في بطونها ـ يتوجب عليه، في المقام الأول، أن ينجز دراسة مطوّلة ومفصلة، مدارها على تاريخ فلسطين منذ أقدم العصور حتى اليوم. فمما هو مخجل لمن يعرف الخجل أن الأرض، التي يجري صراع ملحمي، منذ مائة سنة أو أكثر، ابتغاء حيازتها والهيمنة عليها إلى الأبد، لم يكتب تاريخها أحد سوى أولئك وأنصار أولئك. ومما عساه أن يكون حاجة ملحة، بل ضرورة قصوى، أن نؤلف نحن الفلسطينيين كتاباً بسيطاً صغيراً حول تاريخ بلادنا، وأن نعمل على إدخاله إلى كل بيت من بيوتنا كي يقرأه جميع أطفالنا حيثما كانوا فوق هذه الكرة المنكوبة بالأنذال والمعتوهين، إذ ينبغي أن تتأسس هويتنا على أرضية المعرفة، أقصد معرفة النحن والآخر معرفة يقينية راسخة، هدفها الكشف عن زيف العدو والتأكيد على أنه لا يحوز سوى كومة من قمامة. ومن شأن هذه البرهة أن تهدف إلى تأسيس الشخصية الفلسطينية على مبدأ الفرق أو مبدأ التمايز الذي قد يهبنا كامل الثقة بالنفس لنقول بملء الفم: "إننا نريد وطننا كاملاً غير منقوص، وهذا يعني أننا نريد تل أبيب قبل القدس، إذ إن فلسطين لا وجود فيها لأية ذرة من تراب غير مقدس. ولا مرية في أن الزمن مفتوح على الأبدية وإغلاقه متعذر أو محال." يقيناً، ما من وعي على الأصالة سوى وعي التاريخ، وذلك لأنه ينطوي على السؤالين الأعظمين الراخمين إلى الأبد في الذهن البشري: سؤال القيمة وسؤال المصير. ولا ريب البتة في أن وعي الذات الوطني لا بد له من أن يمر بوعي التاريخ الذي لا يجوز لأحد أن ينظر إليه بوصفه ما قد مضى وانقضى، بل ينبغي ألا يرى إلا من حيث هو والد الحاضر والمستقبل في آن واحد. فإما أن يتمثل المرء علم التاريخ وإما أن يظل منقوص الوعي إلى حد لا تغطية له قط، وما ذاك إلا لأن التاريخ هو العلم بالكل، فمن جهله فقد جهل الدورة الدموية التي تدور في شرايين الأشياء. وفي حال الوضع الفلسطيني، فإن التاريخ هو الذي أنتج ما نحن فيه الآن من بؤس وشقاء، إذ يزعم أولئك أن ماضي فلسطين الذي زوروه على هواهم، هو ما ينبغي أن يقرر حاضرها ومستقبلها، أي إن فلسطين من حقهم إلى الأبد، كما يتوهمون. وما دام الماضي هو علة ما يجري الآن من حوادث، فقد صار التعرف عليه، أو استبار أعماقه، هو الوجوب الثقافي الأول للشخصية الفلسطينية المهمومة بمصيرها، أي بمستقبلها حصراً. وهذا يعني أن علينا أن نجعل حقنا يتجلى ناصعاً كالشمس في مقابل باطلهم الحالك والزائف إلى الحد المثير للاشمئزاز ولئن أنجز المثقفون الفلسطينيون مثل هذا الإنجاز، فإنهم سوف يكونون قد برهنوا على أن الجبهة الثقافية لا تقل أهمية عن الجبهة القتالية في الصيرورة الفلسطينية العظيمة. كما أن هذا الفعل سوف يكون معياراً من المعايير الدالة على جدوى الحراك الفلسطيني المجهّز بالأسانيد الصانعة للخصوصية أو للتفرد الأصيل. ثم إن واحداً من أهم الأهداف التي ينبغي أن يستهدفها وعينا بالتاريخ هو البرهنة على أن أولئك ليس لهم سوى الزيف والانتحال، وكذلك التطفل على المراكز الحضارية الكبرى في منطقتنا، ولا سيما بابل وكنعان ومصر الفرعونية. فمن المؤكد أنهم سرقوا جملة رموزهم من بابل التي وصفها أحد المؤرخين اليونانيين بأنها أعظم مدينة تشرق عليها الشمس. فلا ريب في أن النجمة السداسية والشمعدان السباعي مسروقان من تلك الحاضرة التي كانت تشع حضارة على الدنيا القديمة كلها. ترى، لو كانت كومة أوساخهم قديمة بالفعل، فلماذا سكتت عن أكبر الوقائع التاريخية التي جرت في فلسطين خلال الألف الثاني قبل الميلاد؟ إن مصر الفرعونية قد احتلت فلسطين طوال أربعة قرون، وإن تحوتمس الثالث قد خاض في أواسط القرن الخامس عشر قبل الميلاد معركة كبيرة حول أسوار مدينة مجدو التي نسميها اللَجّون، والتي صارت عاصمة فلسطين في العصر الفرعوني. كما أن الفرعون أحمس، الذي هزم الهكسوس، قد خاض معركة مدتها ثلاث سنوات حول مدينة شاروحين الحصينة والواقعة في جنوب فلسطين، حتى أرغم أولئك الغزاة على الجلاء عنها، وذلك زهاء سنة 1575 ق.م. بل إن أحمس قد طرد الهكسوس من فلسطين برمتها، وظل يطاردهم حتى تخوم الأناضول. ومع ذلك، فإن هذه الحوادث كلها لا ذكر لها في كومة قاذوراتهم على الإطلاق. أن نتحالف مع الحقيقة بينما يتحالف أولئك مع البهتان والإفك، ذلك هو بالضبط بدء المنهج القويم باتجاه النصر الذي أحسبه حتمية تاريخية لا بد منها، وإن طال الزمن. فلقد خيضت في شبه جزيرة إيبيريا حرب طويلة مدتها ثمانية قرون بين العرب والأسبان. حسناً فلتمتد الحروب بيننا وبين أولئك طوال اثني عشر قرناً، ما داموا مغرمين بهذا الرقم الذي سرقوا تمجيده من مدينة بابل، وهي التي عبدت الستة ومضاعفات الستة. ولهذا كله، يتوجب علينا أن نؤكد، وخاصة لأولادنا وأحفادنا، أن هيراقليط، الفيلسوف اليوناني المعروف، قد رسخ أصدق فكرة جاءت بها الفلسفة القديمة والحديثة، وذلك حين قال: "أعدل الأشياء المعركة."
| |||||||
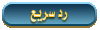 |
 السبت 4 أكتوبر - 10:15:01 السبت 4 أكتوبر - 10:15:01 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط 
|  موضوع: رد: الشعر الفلسطيني في خمسين سنة 1917-1967 موضوع: رد: الشعر الفلسطيني في خمسين سنة 1917-1967 الشعر الفلسطيني في خمسين سنة 1917-1967 ثانياً ـ بداية الشعر في فلسطين صادق في ذهني أن السفينة كانت العامل الأول في مضمار تطوير المجتمعات ونشر الحضارة في جميع أقطار الكرة الأرضية، ولا سيما تلك المجاورة للبحر، أو تلك التي يتيسر اتصالها به دون عوائق. ولولا السفينة الفينيقية حصراً، وبخاصة سفن جبيل، ثم سفن صور، لما كان لمدينة أثينا، ولا لمدينة روما، أن تعرف أي منهما دربها إلى الوجود. ولو لم يجلب الفينيقيون مادة الورق من الصين إلى اليونان لما سمع أحد باسم أفلاطون ولا باسم أرسطو. ففي الحق أن السفينة الفينيقية استطاعت أن تلحم النائيات بعضها ببعض، وأن تعمل على إنجاز مستوى ما من مستويات الوصال بين البشر. وهذه موضوعة لا محل لها في هذا السياق الراهن، وهو المكرس لموضوعة أخرى، وإن تكن هذه الموضوعة الثانية وثيقة الصلة بما يجري في العالم من متغيرات، ولا سيما في مضمار وسائل الاتصال. فمما لا يخفى على اللبيب أن السفينة البخارية الحديثة، التي أصبحت شديدة الشيوع قبل انتصاف القرن التاسع عشر، قد أسهمت أيما إسهام في صنع العالم الحديث كله، إذ لقد يسّرت الاتصال السريع بين أوروبا الغربية، التي كانت مركز الحضارة الحديثة، وبين بقية بلدان العالم التي كانت راكدة ومتخلفة وشديدة الاختلاف عن المركز المتقدم. أما حفر قناة السويس فقد جعل مصر على اتصال دائم بالأوروبيين، حملة الحضارة الحديثة والحياة الجديدة القائمة على تطوير الأدوات تطويراً لم تألفه البشرية من قبل. ولا ريب في أن القناة جعلت وضع مصر يختلف اختلافاً جوهرياً عما كان عليه سالفاً. فالثقافة المصرية الحديثة، التي كانت الصحافة حاملها الأول، لم يقيّض لها أن تزدهر وتنمو على نحو غزير إلا بعد حفر قناة السويس التي ربطت مصر بالشرق والغرب على السواء. ولما كانت فلسطين أقرب البلدان إلى مصر، ولما كان ميناء عكا وميناء يافا ناشطين (منذ القدم) وقادرين على إنجاز الاتصال السريع بمصر قبل سواها من أقاليم الدنيا، فقد نتج عن ذلك أن أعداداً من الطلاب ليست بالطفيفة قد اتجهت إلى القاهرة لتدرس في الجامع الأزهر الذي ظل ما بعد الحرب العالمية الأولى المنارة الثقافية الأولى، لا في مصر وحدها، بل في العالم العربي بأسره. وبفضل اتصال الروّاد الفلسطينيين بالبيئة المصرية المتقدمة نسبياً، فإن حراكاً خصيباً بعض الشيء قد أخذ يتنامى في بلادنا ذات الطابع الزراعي، وإن يكن ذلك الحراك بطيئاً بسبب تخلف فلسطين العثمانية، وكذلك بسبب الضحالة الديموغرافية، إذ لم يكن عدد السكان سوى أربعمائة ألف نسمة زهاء عام 1880. ولا مرية في أن فلسطين كانت وثيقة الصلة بمصر طوال التاريخ، بل إن تاريخها مربوط بتاريخ وادي النيل منذ الألف الثالث قبل الميلاد، ولكن مصر العثمانية نفسها كانت متخلفة وعاجزة عن تحريك جيرانها، أو إيقاظهم على أية حياة جديدة أو متقدمة. ثم إن ما ينبغي التنويه به أن السفن الأوروبية قد أخذت تزور الموانئ الفلسطينية نفسها، حاملة إليها البضائع الصناعية، وآخذة منها البضائع الزراعية، ولا سيما الجنوب. وكان لا بد لهذا الاتصال من أن يسهم في تطوير الحياة الفلسطينية عهد ذاك. ففي الحق أن الإمبريالية الأوروبية ـ على علاتها ومثالبها الشائنة ـ قد أنعشت الآخر، مع أنها نهبته بكل جشع خسيس، وذلك على النقيض من الإمبريالية الجديدة التي لا غاية لها سوى ترميد الإنسان، أو استئصال الجذور التي يطلع منها الروح البشري نفسه. وأياً ما كان جوهر الشأن، فإن المرء لا يتيسر له أن يتحدث عن وجود أي شعر ذي بال في فلسطين قبل بداية الربع الرابع من القرن التاسع عشر، ولكنك تملك حق التوكيد على أن سنة 1880، أو مطلع الثمانينات من القرن نفسه، هي البداية الفعلية للشعر الفلسطيني. وإذا ما علمت بأن الهجرة الصهيونية الأولى إلى أرضنا المهانة قد جاءت من روسيا سنة 1882، فإن في ميسورك القول بأن تلك السنة هي البداية الفعلية لتاريخ فلسطين الحديث، وذلك لأن مجيء أولئك إلى الإقليم هو ما فجر الأزمة التي تؤلف تاريخه الجديد سداة ولحمة. فالمصادر المعاصرة لتلك الآونة قد أشارت صراحة إلى أن أول صدام دموي بين المهاجرين الروس وبين الفلاحين الفلسطينيين قد تم سنة 1886، أي بعد الهجرة الصهيونية الروسية بأربع سنوات فقط. وبذلك يكون القدر العلمي قد أخذ يعمل على صياغة الشخصية الفلسطينية وإعدادها لمهمة جليلة تخصها وحدها من دون البشر، وخلاصتها استئصال ذلك الشر الطاعوني الذي أُسميه أولئك. *** عندما يحتدم الصراع ضد الأغيار في وطن من الأوطان بحيث تصير القضايا التاريخية، أو السياسية، محور الكلية أو الشمول في ذلك الوطن المتوتر، وعندما يغدو سؤال المصير هو السؤال المهيمن على الحياة بإيقاعاتها كافة، فإن الأدب بعامة، والشعر بخاصة، لا يسعه البتة إلا أن يصب جل جهوده على المعضلة الكبرى التي لا تعنو للانحلال إلا على نحو فاجع، لعل من شأنه أن يغيّر مجرى التاريخ المحلي بأسره. وفي الحق أن الشعر قد واظب على التأثر بالحوادث الكبرى الجارية في واقع الحياة التاريخية العامة، أو في سيرورة المصير حصراً، ولا سيما تلك ا لمصائب الجارفة الفاجعة التي يستحق كل منها اسم النكبة أو الكارثة. فحرب طروادة، مثلاً، هي ما يدشن موضوع الإلياذة، والكفاح من أجل روما هو المحتوى الصميمي للإنيادة. أما المعلقات فهي صورة ممتازة عن توترات المجتمع الجاهلي، أو عن بعض تلك الصراعات المحلية التي لا يخلو منها مجتمع قديم. وفي شعر المتنبي ينعكس الصراع المرير بين العرب والروم على نحو شديد الجلاء. ثم إن الشعر الأندلسي لم يترك حادثة كبيرة من حوادث التناحر التي دارت بين العرب والإفرنج دون أن يفرد لها مكاناً خاصاً في ديوانه المنداح. وكان ابن الأبار وابن عبدون وأبو البقاء الرندي من أبرز الشعراء الذين انعكست أحداث عصورهم في أشعارهم، إذ لقد كتبوا قصائد هي بمثابة استجابات صادقة للتاريخ الذي من شأنه أن يسهم أيما إسهام في صياغة ماهية الإنسان. ولكن هذا لا يعني البتة أن الشعر صدى من أصداء التاريخ، أو صورة من صوره، إذ للحق أن الأدب الأصلي لا محتوى له سوى الشعور الإنساني وحده. ومثلما انعكس التاريخ الأندلسي في الشعر الأندلسي، فقد انعكس التاريخ الفلسطيني في الشعر الفلسطيني أيضاً. (والتشابه ناصع بين الماجريات في الأندلس وفلسطين.) وفي الحق أن هذا هو حال الشعر في الكثير من بلدان العالم، ولا سيما بلدان العالم العربي، وخاصة سوريا ومصر والعراق والجزائر. ومما لا يقبل مراءً أن الشعر الفلسطيني لم يتحول إلى حركة عارمة، أو إلى حضور كثيف وغزارة دافقة إلا في معترك الكفاح من أجل الوطن إثر احتلال الإنجليز لبلادنا سنة 1917، إذ ابتداء من هذا العام تقريباً نشأ الشعر الفلسطيني الحديث. ومع ذلك، فإن فلسطين قد أنجبت عدداً من الشعراء قبل ذلك العام الذي دشّن التاريخ الفلسطيني بوصفه خصوصية التصدي للصهيونية الطفيلية المدعومة بالإمبريالية العاتية اللئيمة. ولقد كان يوسف إسماعيل النبهاني (1849-1932) المولود في قرية إجزم القريبة من حيفا، أول شاعر فلسطيني، وفقاً للمصادر التي بين يدي، إذ لم تسعفني تلك المصادر على تحديد أي اسم آخر بوصفه تجسيداً لبرهة ابتداء الشعر في فلسطين الحديثة. والجدير بالتنويه أن النبهاني قد تخرج من الجامع الأزهر في القاهرة، ثم نشر ديواناً شعرياً سماه "الطيبة الغراء في مدح سيد الأنبياء"، وذلك في بيروت سنة 1314هـ/ 1897م. (و"الطيبة"، بفتح الطاء، هي المدينة المنورة.) ولا ريب في أن ذلك الديوان هو أول ديوان شعري ينشره الفلسطينيون، أو واحد منهم. ولهذا، يجوز القول بأن "الطيبة الغراء" هو الديوان الذي يؤسس الشعر الفلسطيني أو يمثل حالة الريادة التي افتتحت العصر الشعري الحديث في فلسطين. كما أن للنبهاني ديواناً آخر عنوانه "المجموعة النبهانية للمدائح النبوية". ولم أوفق في العثور على تاريخ طبعه. ولا بأس في قراءة هذه الأبيات التي يمدح بها الرسول (، وهي من ديوان "طيبة الغراء": نورك الكل، والورى أجزاء يا نبياً من جنده الأنبياء روح هذا الوجود أنت، ولولا ك لدامت في غيبها الأشياء يا رعى الله طيبة من رياض طاب فيها الهوى وطاب الهواء وإذا ما علم المرء أن النبهاني قد درس في الجامع الأزهر لمدة سبع سنوات، فإنه سوف يدرك السبب الذي جعل هذه الأبيات ناضجة ورصينة على هذا النحو الذي قلما يراه المرء في الشعر الفلسطيني قبل إبراهيم طوقان. كما درس في الأزهر شاعر آخر من ذلك الطور هو سعيد الكرمي (1852-1935)، والد الشاعر عبد الكريم الكرمي الملقب بأبي سلمى. ومن المعلوم أن الكرمي اسم منسوب إلى طولكرم الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية مما يعرف الآن بالضفة الفلسطينية. ومما هو لافت للانتباه، أو قل مما هو ذو دلالة شديدة النصوع، أن الشعراء الفلسطينيين في تلك الآونة الابتدائية، أو التأسيسية، قد كانوا من خريجي الجامع الأزهر جميعاً. ولقد كان علي محمود الريماوي (1860-1919)، الذي هو من بيت ريما التابعة لمدينة رام الله، واحداً من أولئك الروّاد المتتلمذين على الثقافة المصرية. ومما يؤسف له أن معظم شعره قد ضاع، كما ضاع شعر صالح التميمي (1877-1922) المولود في نابلس، والذي اشتغل في القضاء معظم سنوات عمره. أما سليم اليعقوبي (1880-1946)، وهو من مدينة اللد، فقد ورثنا عنه ديوانين كاملين، أولهما "حسنات اليراع"، وثانيهما "النظرات السبع". ولم أُوفق إلى معرفة تاريخ الديوان الأول، ولكن الثاني قد نشر في القاهرة سنة 1349هـ/ 1931م. وأما سليمان التاجي الفاروقي (1882-1958)، وهو من مدينة الرملة، عاصمة فلسطين أيام العرب الأوائل، أي في زمن الدولتين الأموية والعباسية، فلم يكتف بالدراسة في القاهرة، بل تابع تحصيله المعرفي في استنبول، حيث حصل على إجازة في الحقوق. ولهذا، فقد اشتغل في المحاماة لبرهة من الوقت، ولكنه غادرها ليعمل في الصحافة التي من شأنها أن تقدم مجالاً واسعاً للتعبير. ومن أهم أخباره أن بصره قد كف منذ كان طفلاً. أما مصيبته الثانية فخلاصتها أن شعره قد ضاع. وقد أتيح لإبراهيم الدباغ (1881-1946) ظرف خاص لم يتح مثله لأي من أولئك الشعراء الرواد. فقد ولد في يافا (ربما لأُم مصرية) وذهب إلى القاهرة ليدرس في الأزهر سنة 1893. وهنالك تتلمذ على أحسن المعلمين في ذلك الزمن. فهو من تلاميذ محمد عبده، المتنور المشهور. كما أنه قد درس على سليم البشري وسيد علي المرصفي. ومن المعلوم أنه كان صديقاً للشاعر خليل مطران. وفي القاهرة أصدر الجزئين الأول والثاني من ديوان له عنوانه "الطليعة"، وذلك سنة 1925 وسنة 1937 على التوالي. *** ها قد صار ناصعاً تمام النصوع أن الشعر الفلسطيني في أبكر أطواره قد راح يشطأ من تربة الثقافة المصرية التي أخذت تنمو وتنتشر ابتداءً من النهضة التاريخية التي أسسها محمد علي باشا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، والتي أسهمت السفينة البخارية أيما إسهام في جعلها أمراً ممكناً بالفعل. ومما هو جد بيّن أن عدد الشعراء الفلسطينيين الذين كانوا يكتبون خلال السنوات الثلاثين، أو الأربعين، التي سبقت الاحتلال البريطاني مباشرة هو عدد ضخم نسبياً، وقد لا يتوفر مثله للكثير من الأقطار العربية الأُخرى. وهذا شأن لا بد من أن يلفت انتباه المؤرخ الأدبي الذي يتوجب عليه أن يعنى بتفسيره على نحو مقبول. وفي تقديري أن تفسيراً من شأنه أن يغفل عمق الاتصال بين فلسطين ومصر ذات الوضع الثقافي الأكثر تقدماً في العالم العربي كله، سوف لن يكون مقبولاً عند الألباء بأي حال من الأحوال
| |||||||
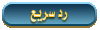 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |

 فقدت كلمة المرور؟
فقدت كلمة المرور؟ فقدت إسم العضوية؟
فقدت إسم العضوية؟